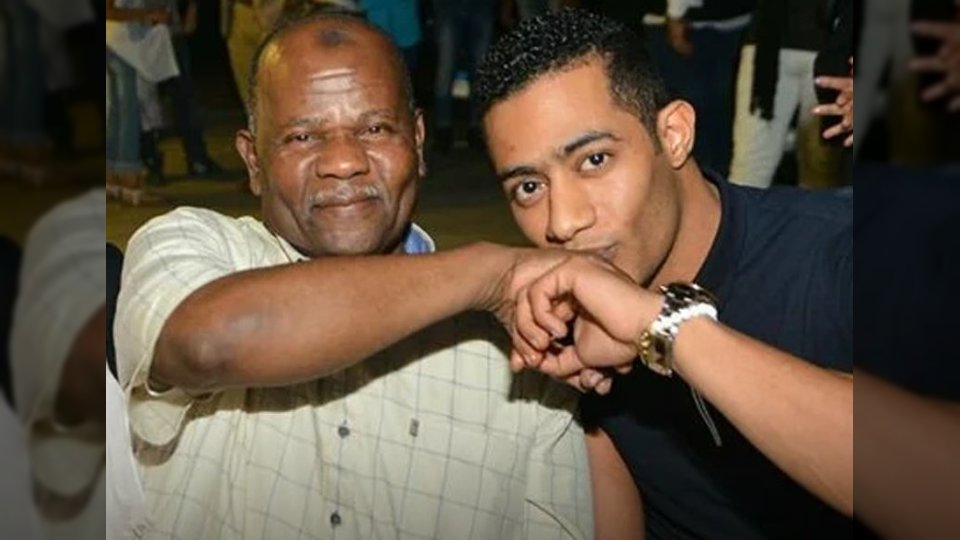ابراهيم ناجي شخصية غريبة تستهوي كل من اتصل بها، شخصية شاعر قلق يحيط بها، ويغمرها السر الذي قذف بها إلى هذا العالم، والذي لا تنفك تتساءل عنه، شخصية خفيفة جامحة لا تلبث أن ترف على الأشخاص والأشياء حتى تحلق في أجواء غير منظورة، أسعد ما تكون بالصمت والتأمل والصفاء.. وزع وقته بين مرضاه وعيادتهم.
” لم يطرق أهل الفن والأدب بابا لطبيب إلا بابه، ولم يستدعوا غيره لعلاجهم. ولم يقف نشاطه عند ذلك، بل قام بالترجمة وإلقاء المحاضرات، وأنشأ رابطة للأدباء يعلم فيها الشباب، ويفتح لهم آفاقا في سماء الشعر والأدب، يحنو عليهم بقلب الأب، كما حني عليه والده من قبل وقد صادفته الكثير من المتاعب والطعنات الغادرة التي تشكك في موهبته الشعرية، وتفوقه في مهنته كطبيب فتح عيادته للفقراء وكل ذي حاجة، وتراكمت على نفسه المرارة، وتجمعت الهموم من حوله..” هكذا وصفه صديقه الأديب ابراهيم المصري .
لقد أضاف للشعر العربي التجديد في الموسيقى والخيال والأفكار والأساليب؛ ففتح آفاقًا جديدة للشعر الرومانسي الذي يغلب عليه الشجن والعاطفة، وخلَّف للحياة الثقافية ثلاثة دواوين شعرية، وهي: “وراء الغَمَام”، “ليالي القاهرة”، “الطائر الجريح”، بالإضافة إلى العديد من الترجمات والكتب الأخرى بعد سبعة عشر عامًا من رحيل أسرته من الأسكندرية إلى القاهرة.
وُلِد إبراهيم ناجي في 31 ديسمبر/كانون الاول 1898م، وذلك في “مدينة الأحلام” بشبرا التي بناها والده أحمد ناجي بالاتفاق مع بعض أصدقائه، حيث شيَّدوا سبعة بيوت في مكان حالم بعيدًا عن الضوضاء والزحام، وكان الأب عصاميًّا طموحًا، وعلى الرغم من تعليمه الضئيل، إلا أنه كان عاشقًا للثقافة وفنون المعرفة فحوى بيته على مكتبة عامرة بنفائس الكتب في كافة مجالات المعرفة .
وفي هذه المكتبة عاش إبراهيم طفولته مع الشعر والرواية والتاريخ، يجلس بين جدرانها بالساعات الطوال لا يشعر بشيء من حوله ويندمج تمامًا في القراءة. ويُقال أنه ذات مرة هروَّل إلى المكتبة وأخذ يقرأ قصة “عذراء الهند” لمؤلفها “أحمد شوقي أفندي”، وإذا أبوه يدخل عليه ويراه على تلك الهيئة فيربت عليه ويشع في عينيه بريق الرضا وأخذ مكانه إلى جواره ليحدثه عن هذه القصة. وهكذا أوحى الأب إلى ابنه وفتح عينيه على مجال الأدب وترك الباب مفتوحًا للحديث الأدبي مرة ومرات، وكان لا يترك فرصة تدفع ابنه للاطلاع إلا اغتنمها فلم يقتصر دور الأب على التوجيه الفني للاطلاع، بل كان بيته منتدى للأصدقاء من محبي الشعر والأدب، وما أحلى تلك الأمسيات على إبراهيم الذي أصغى بآذان مرهفة وحس متقد، مشدود تماما إلى المناقشات والأشعار التي يلقيها أصدقاء أبيه.
الشعر انطلاق الخيال من عقاله
عاش ناجي حياته بين الشعر والطب، ولكنه زاوج بينهما حتى توحدا، فصار يمارس مهنته بقدر كبير من الشاعرية، يقول ناجي: “أخذت أدرس الطب على طريقة فنية، فقد كنت أبتدع لرفاقي الصور وأخترع لهم من فنون الكتابة ما يعينهم على الحفظ وظللت كذلك إلى الساعة التي أكتب فيها هذا.. أزاول الطب كأنه فن وأكتب الأدب كأنه علم، أي أراعي فيه المنطق والتجديد والوضوح”.
في فترة الدراسة توقف ناجي عن كتابة الشعر. يقول الشاعر صالح جودت تلك الفترة من حياة ناجي بقوله: وليس معنى هذا أنه ترك قول الشعر جملة، بل يجوز أن يكون نتاجه قليلًا أثناء طلب العلم، وإن كان من المرجع أن تكون القصائد التي وردت في ديوانه وراء الغمام، والتي قال فيها إنها من شعر الصبا، قد نظمت في تلك الحقبة من حياة الشاعر.
ومن الطريف أيضا أن ناجي كان متفوقا في دراسته، وأعانه على ذلك إجادته للغتين الإنكليزية والفرنسية، يضاف إلى ذلك ذاكرة قوية تحفظ الآلاف من أبيات الشعر، في الرابعة والعشرين من عمره تخرج إبراهيم ناجي في كلية الطب عام 1932، وبدأ حياته العملية كطبيب يتخذ من مهنته جسرا للتواصل الإنساني مع مرضاه، فإذا جاءه مريض وكان فقيرا لا يأخذ منه أجرا، فكما وهب شعره للإنسانية وهب علمه للإنسانية وللمحتاجين فكان مثالًا يحتذى به في شعره ومهنته، في البداية افتتح عيادته بالقاهرة في حي شعبي، وكسب حب الناس وذاعت شهرته، بعدها أغلق العيادة وافتتح أخرى في سوهاج ومنها إلى المنيا، فالمنصورة عام 1972 التي عاد فيها إلى الشعر بقوة، وتجلت موهبته الشعرية وانتشر شعره على صفحات الجرائد، وكان أول ما كتب قصيدة بعنوان “صخرة الملتقى” التي قالها عند صخرة على البحر بأطراف مدينة المنصورة.
وكانت قصيدته هي الشرارة الأولى في اندلاع شعري جديد بما فيها من خيال جامح، وتجديد ارتكز على عاطفه سامية، وهي سمة من سمات الشعر الرومانسي في تمرده على الشعر الكلاسيكي السائد في تلك المرحلة، لذلك تأثر رفاقه من الشعراء بتلك القصيدة، وخرجت قصائدهم إلى الناس تحمل الأثر القوي الذي أحدثه ناجي في نفوسهم، فبات شعر صالح جودت والهمشري وعلي محمود طه بمثابة الورود التي أنبتت على صخرة ناجي أو صخرة الملتقى.. ومن المؤكد أن الصداقة التي ألفت بينهم تركت في نفوسهم آثارا لا تُمحى، وانفعالات متبادلة، فالبيئة واحدة والمعين الذي يغترفون منه واحد.”
بعد العودة إلى القاهرة، انضم الأصدقاء إلى جماعة “أبوللو” والتي ترأسها في ذلك الوقت د.أحمد زكي أبو شادي، وصار ناجي وكيلا لها، ويضيف د.شوقي أبو ضيف: صدر أول عدد منها بعد موت أحمد شوقي في أكتوبر/كانون الاول من السنة نفسها، وتقلد خليل مطران رياستها ونشر ناجي ديوانه الأول وراء الغمام في عام 1943 وفي مقدمة الديوان يقول الأستاذ أحمد الصاوي محمد ظهور هذا الديوان الصغير هو في تاريخ الأدب يوم مشهود وحركة وثابة جديدة، لأنه الشعر الخالص للشعر، والحب الخالص للحب، والرحمة الخالصة للإنسانية.
واختلفت الآراء وتباينت حول هذا الديوان الذي أحدث ردود أفعال وصدى واسع في الحياة الثقافية عقب الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1944، أصدر ناجي ديوانه الثاني؛ ليعكس صدي الحرب وما خلفته من آثار حُفرت في ذاكرته ولمست وجدانه المرهف، فتفجر الشعر من داخله، ويكسو الديوان طابع التأثر الشديد من الحروب، والتحسر على السلام الضائع.
الطائر الجريح
بعد رحيل ناجي في عام 1953 جمع أصدقاء الشاعر كل ما عثروا عليه من شعر له في صباه وشبابه وأصدروا ديوانا لرفيق دربهم، وقدم له الأستاذ محمد عبدالغني حسن، ويعد هذا الديوان مجلدا للأعمال الشعرية الكاملة بالنسبة لناجي، مما سهل الأمر على العديد من النقاد والدارسين لتتبع مسيرته الشعرية، وما يلقي الضوء على ما فيه من تجديد وإضافة للقصيدة العربية، ليظل أرثه الشعري نابضا عبر الأجيال المتلاحقة، وليظل صوته الشعري محلقا في فضاء الشعر بأحلى القصائد التي مزجت بين العاطفة النبيلة والنفس الجياشة والعقل الواعي، الذي استطاع أن يحكم السيطرة على تلك النفس التي تتوق دائما إلى الحرية والانطلاق لتعبر عن نبل صاحبها الذي صادف الكثير من الأهوال والتجارب المريرة، بالإضافة إلى الفرح بإبداعه الشعري وإحساسه بأن ثمة فائدة للشعر، فالطبيب والشاعر هما ناجي الإنسان الذي أحب الناس فأحبوه، وأدركوا صدقه ونبله.
وفي 27 مارس/آذار 1953 كان الشاعر يستمع إلى دقات قلب مريض فهوت رأسه كما يقول صديق عمره صالح جودت، وسكت ذلك النغم الحزين إلى الأبد عن عمر 55 عاما، ولكن صوته الشعري لا زال بيننا شاهدا على إضافته في سماء الشعر العربي. (وكالة الصحافة العربية)