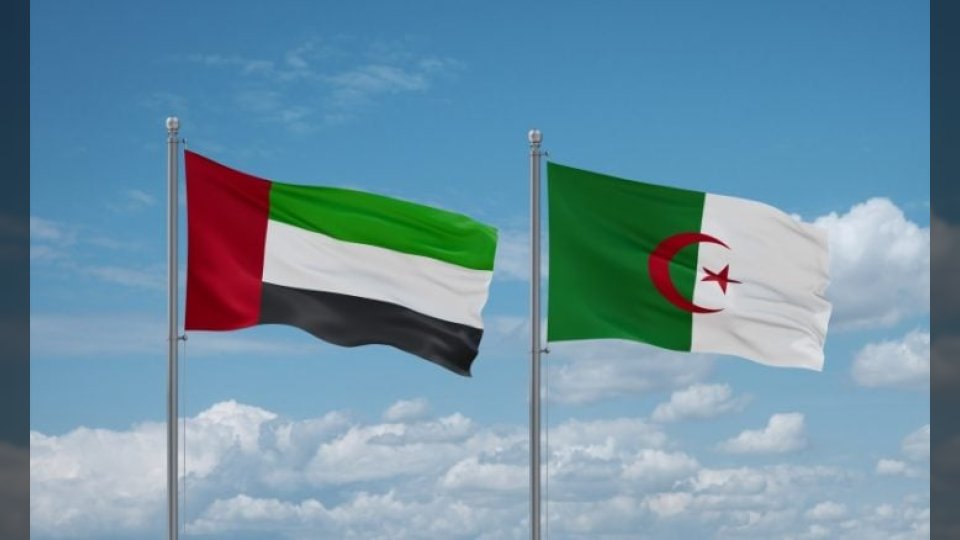نشر موقع «ميدل إيست آي» الإخباري مقالًا كتبه خالد حجي، تناول فيه خطورة حملة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ضد الإسلام واصفًا إياها بأنها تمثل التطرف السياسي في أسوأ صوره، وسلَّط الكاتب الضوء على العلاقات المتأزمة بين فرنسا والدين الإسلامي، مُقدمًا عددًا من الحلول الناجعة لاجتثاث الأزمة من جذورها.
في مستهل مقاله يرى الكاتب، وهو رئيس منتدى بروكسل للحوار الثقافي والديني والأمين العام السابق للمجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، أن السبب في انتشار ظاهرة العنف بين بعض شباب المسلمين في أوروبا يرجع لحد كبير إلى أنهم لا يستطيعون استكشاف أنفسهم داخل القيم والمبادئ الخاصة بالدولة التي يعيشون على أرضها، وليس بسبب اتِّقاد حماستهم الدينية.
يقول الكاتب: ومع التفكير في العلاقات المتأزمة بين فرنسا والدين الإسلامي، تُعيدني الذاكرة إلى نهاية حقبة ثمانينات القرن الماضي، عندما كنت طالبًا شابًا أشارك في احتجاجات حاشدة في باريس ضد ترجمة رواية «آيات شيطانية» للكاتب سلمان رشدي إلى اللغة الفرنسية. وأتذكر الملصقات واللافتات التي كُتب عليها «النبي خط أحمر». ولم يكن الأمر مفهومًا بالنسبة لي حتى سمعت المؤلف إيف لاكوست (عالم فرنسي متخصص في الجغرافيا والجيوسياسية) وهو يُشبِّه الأمر لأحد طلابه خلال إحدى محاضراته قائلًا إنه بمثابة «نقل الأزمة إلى السياق الفرنسي». ولم يكن الأمر مرتبطًا بحرية التعبير والدفاع عن العقيدة الإسلامية أكثر من كونه مسألة من التفكير الجيو-إستراتيجي لإدارة الصراعات وتحقيق المصالح الجيوسياسية.
وأضاف: وما زلت مدينًا بدين ثقيل للاكوست، لأنه نبهني في مرحلة مبكرة من مسيرتي المهنية بصفتي باحثًا في العلاقات بين الإسلام والغرب، إلى حقيقة أن الجغرافيا السياسية مهمة عندما نحاول أن نستوعب أو نفهم العلاقة المضطربة بين أشكال التعبير الفني في الغرب والدين الإسلامي.
الشطرنج الجيوسياسي
لفت الكاتب إلى أن رواية «آيات شيطانية» كان من الممكن أن تمر دون أن تلفت الانتباه أو يلاحظها أحد لولا المتحكمين في الطبيعة الجيو-إستراتيجية. إذ كان السباق المحموم لترجمة الرواية إلى الفرنسية، بالنسبة لعدد من المفكرين والمراقبين الفرنسيين آنذاك، بمثابة انحراف عن المخطط الجيوسياسي لتوريط فرنسا في الصراع بين إيران والمملكة المتحدة.
وظنوا أن الصيحة المعلنة من أجل حرية التعبير كانت مجرد خطوة ذكية على الشطرنج الجيوسياسي. وساندت فرنسا ودول أوروبية أخرى لندن في موقفها للدفاع عن حرية التعبير، وهو ما أدَّى إلى تعطيل علاقاتهم مع إيران وإعاقة حصصهم في سوق إعادة إعمارها.
وصحيحٌ أنه مر أكثر من ثلاثة عقود على نشر رواية رشدي، لكن فرنسا والدين الإسلامي وجدا أنفسهما من جديد محاصَرْين في نفس المناوشة القديمة بشأن العلاقة بين حرية التعبير واحترام العقيدة. وتورَّط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مسار لا رجعة فيه من المواجهة التي لا تقتصر على الراديكاليين والمتطرفين فحسب، بل تمتد إلى المسلمين في شتى بقاع الأرض، ومن سائر مناحي الحياة داخل فرنسا وخارجها.
ويرى الكاتب أن ماكرون افتقر في إدارته للأزمة الحالية إلى الوضوح والتمييز، وأخفق في تحديد عدوه الحقيقي للأسف. ونتيجةً لذلك لم يُثر غضب خصومه الجيو-إستراتيجيين فحسب، مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بل نأى بنفسه أيضًا عن حلفائه التقليديين في محاربة التطرف. وانغمس ماكرون، حتى قبل الحادثة المروعة لقطع رأس أحد المُدرِّسين الفرنسيين لأنه عرض أمام تلاميذه بعضًا من الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد، في تعميمات سيئة وطائشة من خلال الخلط بين عيوب فرنسا الاجتماعية، والتطرف الإسلامي و«أزمة» الإسلام. ويهدف خطاب ماكرون الملتوي إلى استقطاب التطرف اليميني محليًّا، مع وضع الانتخابات القادمة نُصْب عينيه.
السير على خط رفيع
وأوضح الكاتب أن ماكرون أثار لدى حلفائه المسلمين المعتدلين، فضلًا عن المتطرفين، انطباعًا بأنه غير كفء لتحقيق التوازن أو الموائمة بين محاربة الإسلام السياسي وتقويض مبادئ العقيدة الإسلامية. وارتكب خطأ وحماقة كبيرة عندما تبنى خطابًا يعلن فيه أن قبول الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد بمثابة اعتدال ديني، وأن إدانتها تعد تطرفًا دينيًّا.
وأضاف الكاتب قائلًا: إن موقف الرئيس الفرنسي تفوح منه رائحة شكل من الأشكال غير المقبولة من الديانة المانوية (ديانة أهل بابل، والعراق قبل الإسلام، وهم من أطُلِق عليهم الزنادقة في العصر العباسي). وهذا ما يُعد شكلًا واضحًا من أشكال التطرف السياسي، إذ يحاول الرئيس الفرنسي إخضاع المواطنين الفرنسيين ذوي الأصول الإسلامية للاختيار ما بين قبول عرض الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد على جدران الحكومة، أو تمزيق الروابط التي تربطهم بقيم الجمهورية الفرنسية ومبادئها. وعندما ندقق أكثر، سنُدرك أن هذا النوع من التطرف السياسي، مثله مثل التطرف الإسلامي، يعود إلى التعريف البسيط للصواب والخطأ.
وما من شيء أشد عبثية وخطورة من اللجوء إلى التطرف السياسي لمحاربة التطرف الديني. كما أنه ما من شيء يمثل ضيق الأفق في أبسط صوره سوى أن تُنسب مسؤولية العنف الذي يرتكبه مجرمون من أصل مسلم إلى «أزمة الإسلام» العالمية.
يقول الكاتب: إن تجربتي الطويلة في العمل مع الشباب المسلم في أوروبا أظهرت لي أن السبب في ظاهرة العنف المنتشرة بينهم يرجع إلى حد كبير إلى حقيقة أنهم لا يستطيعون استكشاف أنفسهم في القيم والمبادئ الخاصة بالدول التي يعيشون على أرضها، وليس بسبب اتّقاد حماستهم الدينية. وإن ما يُثير الحيرة والارتباك أن نرى الشباب الذين يلعنون الرب على نحو روتيني هم الذين يندفعون إلى الانتقام بسبِّ النبي.
ولا يساورني أي شك في أنه ما لم يُقبل هؤلاء الشباب باعتبارهم شركاء في المجتمع ويُزكى لديهم الإحساس بالانتماء إلى البلاد، فلن ينخفض مقدار العنف المنتشر بينهم. وفي كثير من الأحيان، لا يزيد الدين عن كونه مجرد خط فاصل في محاولاتهم الحالية للتفاوض بشأن إحساسهم بالهوية في الإطار الأوروبي الصعب.
أوقات عاصفة
وتابع الكاتب قائلًا: إنه من أجل التصدي لعوائق الاندماج في المجتمع الفرنسي والعيش معًا، ليس من المفيد الإشارة إلى أن الإسلام يعاني أزمة في العالم بأسره، والتهوين من أزمة الهوية الأوروبية في حقبة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولا ريب أن فرنسا تمر بأحد أكثر أزمانها اضطرابًا في التاريخ، إذ أنها غير واثقة من خطواتها المقبلة. وتفرض علينا الأزمات الاقتصادية والسياسية والفلسفية المتلاحقة ضرورة إعادة تعريف معنى أن تكون مواطنًا فرنسيًّا، إلا أن هذا يُبرز خطر الوقوع في فخ خطابات التطرف السياسي.
إن التطرف السياسي، بالتأكيد، هو الادِّعاء بأن الجمهورية قادرة على تحديد كيف تكون مسلمًا. ولن يُلحق الضرر بالاندماج المجتمعي والعيش معًا أكثر من محاولة إلزام الدين الإسلامي بالتكيف مع جغرافية الجمهورية، في ظل الادِّعاء بأن الإسلام داخل البلاد يختلف عن الإسلام خارجه. ويمكن مقارنة مثل هذا التوجه من الأفكار من عدة جوانب مع نظرية «صراع الحضارات». وفي كلتا الحالتين يعتمد الحل على الفصل الجغرافي: «المسلمون السيئون لا يستحقون أن يعيشوا هنا، إنهم ينتمون إلى مكان آخر».
وخلُص الكاتب إلى أنه من الحكمة فصل الإسلام عن التطرف. وهذه هي الطريقة الوحيدة لتجريد المتطرفين الذين يحاولون اختطاف العقيدة الإسلامية من سلطة محاولة إيجاد مبرر أخلاقي لأفعالهم الإجرامية وأعمالهم الإرهابية. ولا يُعد المجرم أو الإرهابي أحد منتجات الثقافة الإسلامية فحسب، بل إنه أيضًا نتاج عيشه داخل الجمهورية الفرنسية وانتسابه إلى مدارسها وسياساتها المتعلقة بالهجرة ونسيجها المجتمعي.
ومن الظلم والخطأ أن نضع المسلمين في موقف محرج بشأن مسألة «قيم الجمهورية». ويلمح هؤلاء الذين يشعرون بالقلق حيال التزام المسلمين الفرنسيين بقيم الجمهورية إلى أن المسلمين هم العائق الوحيد أمام التوافق الحالي حول «القيم الفرنسية». وأبرز الكاتب أن المجتمع الفرنسي في حقيقة الأمر، حاله مثل حال المجتمعات الأخرى في جميع أنحاء العالم، لا يقل عنها شيء في التشتت بين قيم الماضي والحاضر، وعدم وضوح الخطوط الفاصلة بين «نحن» و«هم».
أزمة وجودية
وفي نهاية المطاف – يختتم الكاتب – لا يمكننا سوى أن نرجو ألا يُسفر تواصل ماكرون غير الحاذق مع العالم الإسلامي إلى ردود فعل مبالغ فيها قد تُشتت انتباه المسلمين عن عدد من الأسئلة الأساسية. ولم تزل تعد فرنسا في تصور شباب المسلمين مكانًا أفضل للعيش فيه من عدد من الدول الإسلامية، لذا فإنهم يُخاطرون بحياتهم من أجل الوصول إلى شواطئها فارِّين من أوطانهم.
واختتم الكاتب مقاله بدعوة المسلمين الفرنسيين والمسلمين الأوروبيين كافة إلى ضرورة المساهمة في ترسيخ ثقافة الحرية والمساواة في الحقوق وسيادة القانون. والمفارقة أن تحقيق كرامة أغلب الشعوب في العالم الإسلامي يعتمد على تطبيق هذه القيم والمبادئ. إن العالم الإسلامي يواجه في الوقت الراهن أزمة وجودية خطيرة، ولن يضع حدًا لهذه الأزمة سوى التفاعل مع العالم الخارجي والانفتاح عليه. وبخلاف ما يريده بعض المتطرفين، فإن الإسلام لا يُعد نظامًا من المبادئ التي تعارض التآزر بين المسلمين وغير المسلمين والتعاون بينهم.