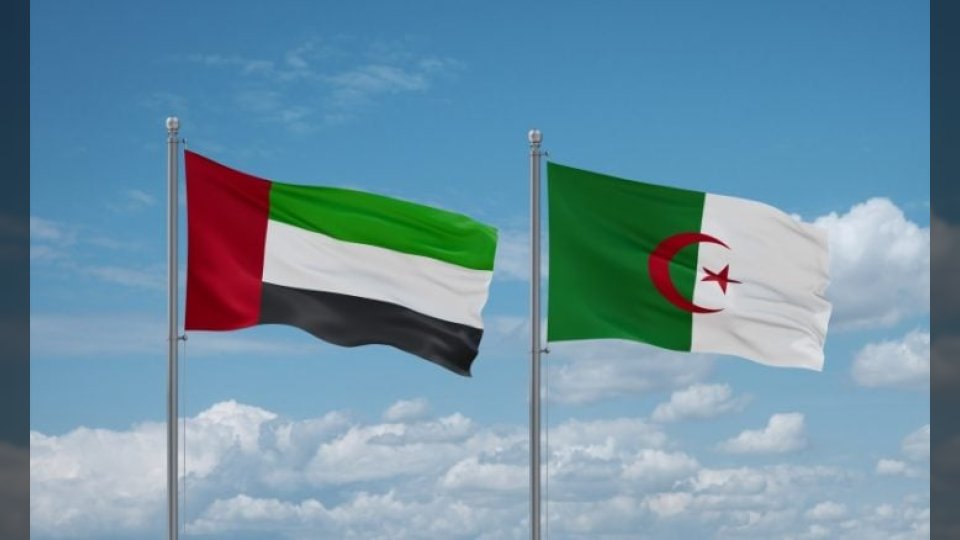لا يزال مصير الحراكيين الشعبيين ضد النظامين القائمين في كل من الخرطوم والجزائر في حكم المجهول. فرغم مرور أكثر من أربعة أشهر على اندلاع المظاهرات في السودان، وبعد أكثر من شهرين على نظيرتها في الجزائر لا تبدو بوادر انتقال سياسي سلس نحو حكم مدني في الأفق.
ففي السودان وصلت المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير، التي انبثقت عن حراك الشارع، وأعضاء المجلس العسكري، الذي يدير دفة الحكم في البلاد، الى ما يشبه الطريق المسدود، بسبب خلاف الجانبين حول طبيعة وشكل هياكل السلطة الانتقالية.
ففيما تطالب قوى الحرية والتغيير بمجلس انتقالي من خمسة عشر عضوا يشكل العنصر المدني الأغلبية فيه، يرفض المجلس العسكري هذا الاقتراح جملة وتفصيلا ويعرض مجلسا من عشرة أعضاء تقتصر مشاركة المدنيين فيه على ثلاثة أعضاء فقط..
ويرى المجلس العسكري أن مطالب قوى الحرية والتغيير بكامل السيطرة على مجلس الوزراء والبرلمان، وبجزء من مجلس السيادة، غير مقبولة على الإطلاق.
وإثر خروج هذا الخلاف إلى العلن بدا أن مواقف الطرفين بدأت تنحو نحو التصعيد بإعلان الفريق محمد حمدان – نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي- عدم السماح بما وصفه بالفوضى وحالة الانفلات الأمني. وقال في مؤتمر صحفي: “لن نقبل بأي فوضى أو اعتداء على المواطنين أو ممتلكاتهم أو مقدرات الدولة” وأضاف: “سوف يتم التعامل بالحزم اللازم وفق القانون.” ومع ذلك شدد أعضاء المجلس العسكري على أن باب الحوار سيظل مفتوحا امام ممثلي المحتجين.
أمام رفض العسكر لمقترحاته، تعهد تحالف قوى الحرية والتغيير بالعودة الى طاولة التفاوض بمقترحات جديدة، محتفظا في الوقت ذاته بضغوطه على المؤسسة العسكرية من خلال الدعوة إلى مظاهرات مليونية في ساحة الاعتصام في الخرطوم.
وإذا كان الحوار بين الجيش وممثلي المحتجين في السودان قد قطع أشواطا – تبعث على التفاؤل نوعا ما وإن لم تسفر عن نتائج تذكر حتى اليوم – فإن الوضع في الجزائر أكثر تعقيدا حيث لا وجود لأي حوار، على الأقل في العلن، أو قناة اتصال بين حراك الشارع والمؤسسة العسكرية التي تدير دفة الحكم في البلاد، بواجهة مدنية ممثلة في الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح.
فلا المتظاهرون اختاروا أو أعلنوا عمن يمثلهم ولا المؤسسة العسكرية، التي لا تريد الخروج عن النص الدستوري في إدارة هذه الأزمة، دعت بعضهم إلى الحوار.
وحتى لو تأكد وجود نية حقيقية لدى المؤسسة العسكرية الحالية في الجزائر، بقيادة الفريق أحمد قايد صالح، للتجاوب مع مطالب الشارع وإقامة نظام سياسي جديد في البلاد، فإن هذه الرغبة تصطدم بعدم وجود طرف مقابل يرضى عنه الشارع، يمكن أن يفتح حوارا مع الجيش ويبحث معه حلولا وسط تحافظ على هياكل الدولة وتعبر بالبلاد إلى بر الأمان.
وتكمن المشكلة هنا في أن الحراك الشعبي، الذي يقود المظاهرات منذ شهر فبراير الماضي، لم يتمكن من إنجاب أي قيادة تتحدث باسمه. فهذا حراك نبع بشكل عفوي من الشارع وحدد مطالب أولية وظل يضيف إليها أخرى جديدة بمرور الأيام والأسابيع.
ورغم أن الحراك الشعبي في الجزائر يفتقر إلى قيادة سياسية، فإن جماهيره تجمع على القطع مع كل الأحزاب السياسية والنقابات التقليدية – الموالية والمعارضة – وترفض انضمامها لحراكه ومظاهراته أو الحديث باسمه.
ورغم الضغوط الشعبية الكبيرة التي تواجهها المؤسسة العسكرية في الجزائر فإنها لا تزال متماسكة، بقيادة رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح، الذي تتقلب تصريحاته منذ اندلاع المظاهرة، قبل حوالي 10 أسابيع، بين دعم مطالب الحراك تارة والتعبير عن قرب نفاذ صبره منها تارة أخرى. وعلى عكس الوضع في السودان لا تبدو في الأفق بوادر حل قريب في الجزائر.
ويلخص الوضع الحالي في كل من الجزائر والسودان أزمة تدخل الجيش في الحياة السياسية في بعض أنظمة الدول العربية وعلاقته بمؤسسة الحكم والرئاسة. فبالرغم من نجاح الحراكين في الإطاحة برأسي النظامين في العاصمتين فإن المرور الى مرحلة انتقالية وفق رؤية الشارعين تواجه صعوبات.
وتتراوح هذه الصعوبات بين تمسك المؤسسة العسكرية بتلابيب الحكم والسلطة وبين مخاوفها من حدوث فراغ سياسي يؤدي الى انهيار هياكل الدولة ووصول تيارات سياسية قبلية أو طائفية أو دينية الى السلطة لا تملك قوة التحكم في أطراف بلد مترامي الأطراف. وقد يجر تغيير النظام السياسي الحالي إلى آخر ديمقراطي على الجيش شر محاسبة عناصره – باسم العدالة – على ما مضى من تجاوزات الحكم السابق.
ولربما كان تدخل أطراف أجنبية عربية وغربية في حراك البلدين في محاولة لإعادة إنتاج نظامين سياسيين مواليين لها عاملا إضافياً يؤخر الحل في العاصمتين.